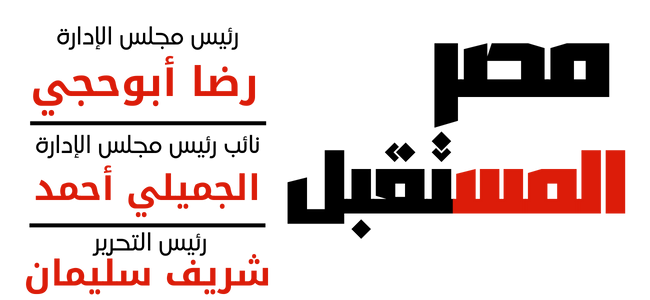الجميلي أحمد يكتب: محمد البريكي… الشاعر الذي جعل من القصيدة بيتاً يسكنه الجميع

محمد عبد الله البريكي… الشاعر الذي جعل من القصيدة بيتاً يسكنه الجميع
لم ألتقِ الشاعر محمد عبد الله البريكي يوماً، ولم يجمعني به حديث مباشر أو تعامل مهني، غير أنني – كما كثير من المتابعين للشأن الثقافي العربي – أجد نفسي مأخوذاً بحضوره المختلف، وبذلك النفس الهادئ الذي يدير به مشاريعه الأدبية والإعلامية وكأنه يزرع بوعي وحنوٍّ حقلاً من الشعر في زمنٍ تتناقص فيه المساحات الخضراء للكلمة.
متابعتي له لم تكن من باب الفضول، بل من باب الإعجاب بشخص استطاع أن يحوّل العمل الثقافي من أداء وظيفي إلى رسالة، ومن الشعر كفنٍّ إلى الشعر كهوية وانتماء.
محمد عبد الله البريكي اسم لا يمرّ في المشهد الإماراتي والعربي مرور الكرام. فهو شاعرٌ يعرف تماماً كيف يصنع توازناً نادراً بين الموهبة والإدارة، بين الحلم والإنجاز. كونه مدير بيت الشعر في الشارقة لم يكن مجرّد منصبٍ إداري، بل تحوّل على يديه إلى مشروع إنسانيّ عربيّ الطابع، أعاد للقصيدة مكانتها وكرّس للشاعر العربي منبراً حقيقياً في زمنٍ تكدّست فيه المنابر وقلّ فيها الصدق.
في كل ما يقدّمه – سواء عبر مهرجان الشارقة للشعر العربي، أو من خلال مجلة القوافي، أو برامجه الإعلامية التي تنبض بهدوء الفكرة وعمق المعنى – تلمس روح المثقف المسؤول، لا المتكلّف، الذي يفهم أن الشعر ليس ترفاً لغوياً، بل ضميرٌ حضاريّ ينطق باسم الناس ويؤنسن الواقع.
إنه من القلائل الذين استطاعوا أن يُزاوجوا بين لغة القصيدة ولغة الحياة، وأن يجعلوا من الشعر جسراً بين الإنسان ونفسه، لا بين الشاعر وجمهوره فقط.
تجربته الشعرية – سواء في قصائده الفصحى أو النبطية – تعكس وعياً حقيقياً بالتحوّلات التي يعيشها العالم العربي. لغته شفيفة دون أن تفقد عمقها، وموقفه من القصيدة واضح: إنها ليست إعلاناً عن الذات بقدر ما هي بحثٌ عن المعنى وسط ضجيج الواقع.
يكتب البريكي كمن يتحدث مع العالم من وراء نافذة، يراقب بحذر ويحبّ بصمت، ويترك في كل بيت شعري أثراً يشبه أثر الخطوة الأولى على الرمل قبل أن تبتلعها الأمواج.
أما على المستوى الثقافي العام، فقد أصبح اسمه مرتبطاً بحالة من النهضة الأدبية المؤسسية التي تُنسب إلى الشارقة، تلك الإمارة التي آمنت بأن الثقافة فعلُ بناءٍ لا يقل عن العمارة المادية. والبريكي، في هذا السياق، هو أحد مهندسي هذا البناء، يخطط للمشهد ويمنحه شكلاً ومعنى.
جهوده في جمع الشعراء العرب تحت مظلة الحوار والتبادل الثقافي ليست مجرّد نشاطاتٍ بروتوكولية، بل هي فعل استمرارية لروح الشعر العربي الممتدة من المعلقات إلى القصيدة الحديثة.
ما يميّز محمد عبد الله البريكي أيضاً هو قدرته على الإصغاء للآخر. في أمسياته ومشاريعه، يفتح الأبواب أمام الأصوات الجديدة دون أن يضع بينها وبين الكبار أسواراً من المقارنة أو الوصاية. إنه يملك حسّ الراعي لا الحارس، والمثقف الذي يرى في كل شاعرٍ احتمالاً للضوء، لا منافساً في الحضور.
في زمنٍ صارت فيه الثقافة تُدار بلغة الأرقام والمتابعات، ما زال البريكي يُديرها بلغة القيم والرؤية. ولعلّ هذا ما يجعل حضوره هادئاً لكنه مؤثر، بسيطاً في ظاهره لكنه عميقٌ في أثره.
إنه مثال للمثقف العربي الذي لم يغادر أرضه رغم انفتاحه على العالم، والذي يرى في الشعر طريقاً لبناء إنسانٍ أفضل، لا مجرد قصيدة أجمل.
ولعل أجمل ما يمكن أن يُقال عن محمد عبد الله البريكي هو أنه لم يجعل الشعر مهنةً، بل جعله قدراً ومسؤولية. في حضوره ترى أن الكلمة ما زالت قادرة على أن تكون بيتاً، وأن القصيدة يمكن أن تكون وطناً صغيراً يتسع للجميع.
ولعلّ هذا المقال، بكل ما حمله من تأملات وانطباعات أولى، يكون عندي بمثابة افتتاحية لدراسة مطوّلة عن شعر وحياة محمد عبد الله البريكي؛ دراسةٍ أرجو أن تتجاوز ظاهر السيرة إلى عمق التجربة، وأن تتناول ملامح مشروعه الإبداعي في الشعر والإدارة والثقافة بوصفه نموذجاً لنهضة الوعي الأدبي العربي في زمنٍ يعيد تعريف ذاته. فكل سطرٍ يكتبه البريكي، وكل فعاليةٍ يرعاها، وكل فكرةٍ يطلقها من منابر الشارقة، تستحق قراءةً متأنية تكشف كيف يمكن للشاعر أن يكون صانع معنى، لا مجرد صانع كلمات.